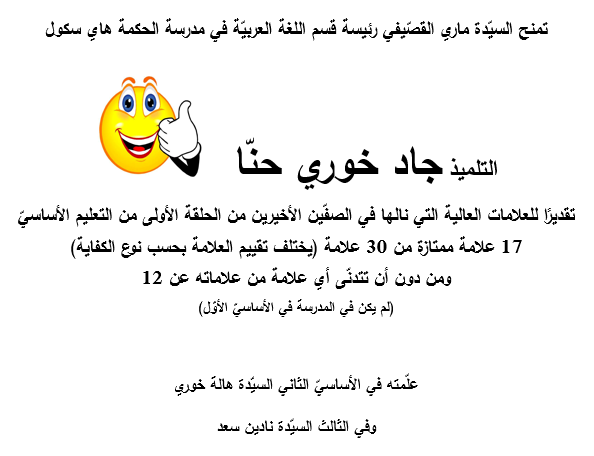المقاهي بهذا المعنى هي رئة المدينة وفضاؤها، وهي المنصة الدائمة لبوح أبنائها وشكاواهم، وللتنفيس عن همومهم، وللاحتجاج على واقعهم المعيش عبر التعليقات الطريفة والنكات الساخرة. وإذا كانت المقاهي الشعبية قد عبّرت عن حاجة الطبقات الدنيا والشرائح الفقيرة إلى الترفيه عن نفسها من خلال ألعاب الورق والنرد وتدخين النارجيلة، فإن مقاهي المثقفين في المدن الحديثة بدت تلبيةً لحاجة النخب الطليعية إلى مسرح يومي للتواصل وتلاقح الأفكار ونقد الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي وصولاً إلى التغيير المنشود.
هكذا كان الحال في مدن الغرب الأوروبي كبرلين وباريس وروما ولندن التي تحولت مقاهيها إلى قابلات للتنوير وحاضنات للمغامرات الإبداعية الجديدة وللمدارس الفلسفية والأدبية المتصارعة. وهكذا كان الأمر في عواصم العرب ومراكز نهضتهم السياسية والثقافية، حيث توزع مثقفو بغداد في القرن الفائت بين مقاهي (الشاهبندر والزهاوي وحسن عجمي)، وتوزع مثقفو القاهرة بين مقاهي (ريش والغريون والفيشاوي وزهرة البستان)، وتوزع مثقفو دمشق بين (اللاتيرنا والروضة والنوفرة وهافانا).
أما بيروت فقد عكست مقاهيها المنتشرة في سائر الأحياء دينامية المدينة الاستثنائية وتنوع ثقافاتها وتقاليدها وشرائحها الاجتماعية. وإذا كانت مقاهي وسطها القديم قد نجحت في استقطاب الكثير من الشعراء الكلاسيكيين، وافدين ومقيمين، من أمثال أحمد الصافي النجفي والأخطل الصغير ومحمد علي الحوماني وعمر أبو ريشة وأمين نخلة، فإن مغامرة التحديث الحقيقية كانت تتنامى في مكان آخر، حيث اندلقت المدينة خارج أسوارها الأم وتمكنت الجامعة الأميركية منذ أربعينات القرن الفائت من أن تكون عنصر الجذب الأهم بالنسبة إلى المثقفين اللبنانيين والعرب، وأن تحوّل شارع «بلس» بمطاعمه ومقاهيه مثل «فيصل» و«الأنكل سام»، لا إلى بؤرة معرفية وتنويرية فحسب، بل إلى مصنع لتوليد العقائد والأحزاب والآيديولوجيات، وصولاً إلى التخطيط للانقلابات السياسية وتغيير أنظمة الحكم القائمة.
وغير بعيد عن شارع «بلس»، كان شارع الحمراء يتقدم من الخطوط الخلفية للمشهد ليؤازر في البداية جاره الآخر الموازي، وليصبح خلال فترة وجيزة قبلة أنظار السياح والوافدين، ممن رأوا فيه صورة لبنان الأزهى وعنوان انفتاحه والترجمة المرئية لهوس اللبنانيين بالأناقة والجمال، ولشغفهم بالحياة.
ولا نستطيع أن نغفل في هذا السياق ما لاسم «الحمراء» ذاته من صدى عميق في المخيلة العربية الجمعية التي يحيلها الاسم تارة إلى قصر الحمراء في غرناطة الأندلسية، وطَوْراً إلى اللون الأحمر المنبعثة هواماته من أحشاء الملاهي وعلب الليل لتدغدغ النفوس العطشى والأجساد المكبوتة. وفيما لا ينكر سمير قصير في كتابه القيم «تاريخ بيروت» مثل هذه التأويلات، يشير في الوقت ذاته إلى أن التسمية الفعلية تعود إلى عائلة الحمرا الفارسية التي كان أبناؤها يترددون على بيروت منذ القرن الثاني عشر الميلادي. وإذا كانت منطقة رأس بيروت بما تحمله من تنوع ثقافي وديني واجتماعي هي النموذج المصغر عن صورة لبنان ومعناه الحقيقي، فإن شارع الحمراء الممتد طولياً من منطقة الصنائع حتى أطراف كاراكاس استطاع خلال سنوات قليلة أن يصبح المنصة الأكثر جرأة لإطلاق حركة الحداثة والتجديد في لبنان الستينات والسبعينات، والمقر الأبرز للصحف والمجلات والأندية الثقافية والمسارح ودور السينما، إضافة بالطبع إلى كونه مركزاً مهماً للتجارة والخدمات والترفيه وتقديم عروض الأزياء. ولم يكن لدوْر الشارع أن يكتمل من دون تلك المقاهي الأنيقة التي وجدت فيها النخب المثقفة ضالّتها ومتنفسها وسبيلها للتلصص على العالم، ولمتابعة نهر الحيوات الإنسانية الذي لا يكفّ عن الجريان. فعلى امتداد الشارع كان عشرات الكتاب والفنانين يتوزعون بين مقاهي (الألدورادو، والستراند، والهورس شو)، وصولاً إلى (الإكسبرس، والمودكا، والويمبي، والكافي دو باري، وغيرها). وهناك حيث كنا لا نزال طلاباً في الجامعة قادمين من أريافنا البعيدة، تأتّى لنا أن نشاهد عن بُعد وجوه أنسي الحاج ويوسف الخال وأدونيس وعصام محفوظ وشوقي أبي شقرا وخليل حاوي، وأن نحلم بمجالستهم حين تسنح لنا الفرص.
وإذا كان شارع الحمراء هو الثمرة الطبيعية لتقاطع التجارة مع التنوير، فإن الحرب اللبنانية الطاحنة قد أفرغته شيئاً فشيئاً من بُعده الثاني وحوّلته إلى ساحة لمتاريس العنف المتقابلة. هكذا أُقفل مسرح «البيكاديلي» الذي وقف على خشبته الساحرة أساطين الفن والموسيقى من أمثال فيروز والرحبانيين ووديع الصافي وصباح وفيلمون وهبة، وصولاً إلى بافاروتي وميكيس ثيودوراكيس وغيرهما على المستوى العالمي. وأُقفلت بعده دور السينما والمسرح واحدة إثر أخرى، فيما تكفلت دولة الطوائف المتحاصصة بعد الحرب، بتصحير ما تبقى من دوره الثقافي الريادي.
وبتأثيرات مباشرة من العولمة الزاحفة واستشراء نظام السوق وقيم الربح الصِّرف، وأقفلت تباعاً مقاهي الشارع التاريخية، بدءاً من (الإكسبرس، والهورس شو، والمودكا، والويمبي) ووصولاً إلى «الكافي دوباري».
لقد استبدلت بالمقاهي – المنارات، مطاعم الوجبات السريعة أو شركات الألبسة الجاهزة التي أنشئ بعضها لتمويه تبييض الأموال، دون أن يلتفت أحد من المعنيّين إلى المناشدات التي طالبت بحراسة الذاكرة الوطنية من التلف والتلاشي.
صحيح أن مقاهي أخرى قد أنشأتها الشركات المعولمة والعابرة للقارات على أنقاض تلك القديمة أو إلى جوارها، ولكن فضاءاتها الربحية الضيقة وأوقاتها المقننة لا تتسع للنقاشات والحوارات الخلاقة ولا لصناعة الأحلام. هكذا وجد المثقفون اللبنانيون أنفسهم «مشردين» وتائهين في الأماكن التي لطالما وهبوها أقلامهم وقلوبهم وضوء عيونهم وأعمارهم الآيلة إلى ذبول. وفي حين انتقل بعضهم إلى مقهى «الروضة» المجاور للبحر، بوصفه خط الدفاع الأخير عن هواء المدينة، عاد آخرون إلى «كوستا» الذي أنشئ على أنقاض الهورس شو وفي مكانه بالذات، والذي لم يصمد هو الآخر أمام عتوّ المنافسات والمضاربات الريعية المحمومة، تاركاً رواده القلائل ينزحون باتجاه مقهى «الكاريبو» المجاور.
القليلون، أخيراً، يدركون أن مقاهي المدن ليست مجرد أماكن للتبطل والتمرن على الكسل وتصريف الأعمار، بل هي أماكن للصداقة والحب والثراء المعرفي، ولتجديد العقد مع الأمل. وهي للكثير من الشعراء والكتاب، وأنا واحد منهم، أماكن للإلهام واجتراح القصائد واستيلاد المجازات وانتزاعها من عهدة الصمت. وبيروت بلا مقاهيها القديمة هي مدينة بلا ذاكرة ولا شرفات للتأمل أو الحنين. وهي عاصمة لا تجد من «يعصمها» من ألزهايمر المدن وتشتت المعنى وضياع الهوية.